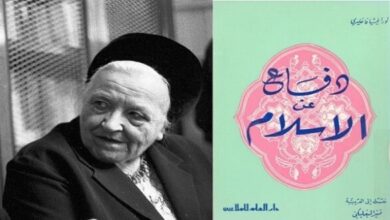الدين الحق تعاليمه متصلة السند بالنبي المُرسل


الحكمة الإلهيّة تقتضي تزويد الإنسان بطريق الهداية إلى الله تعالى، غير طريق الحسّ والعقل لقصورهما وعدم قدرتهما بذاتهما على معرفة طريق الهداية إلى الله بكلِّ أبعاده وتفاصيله. فكانت الحاجة إلى طريق آخر غير الحسّ والعقل، وهذا الطريق هو طريق الوحي والنُّبوَّة. وعلى مدى تاريخ البشر، من لدن آدم –عليه السلام- وحتى مُحمَّد –صلى اللَّه عليه وسلّم-، اختار اللَّه عزّ وجلّ أنبياء واجتباهم وأرسلهم إلى الناس ليخرجوهم من ظلمات الشرك إلى نور الهداية والتوحيد، ففيهم المثل الأعلى، والقدوة الحسنة، التي تهدف إلى تربية الناس على الخير الخالص بما تقول وبما تفعل. ولذلك كان لابد للدين الحق أن يبلّغه نبي مُرسل، ولابد أن تكون تعاليم هذا الدين متصلة السند بذلك النبي، إذ إن اتصال السند شرط أساسي للتأكد من أن تعاليم هذا الدين وتشريعاته من عند الله عزّ وجلّ، ولم تصل إليها يد البشر فتخرجها عن إطارها الرباني. ومن أخطر الخطر أن يعبد الإنسان ربّه بشيء لا يدري مصدره النهائي، أو غير متأكّد منه.
ومن بين جميع الأديان التي يدين بها سكان العالم اليوم، فإن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تتصل تعاليمه وتشريعاته بسند صحيح إلى النبي المُرسل، وهو مُحمَّد –صلى الله عليه وسلم-. فالقرآن الذي بين أيدينا اليوم، وهو دستور الإسلام، ظل يتوارثه الحُفَّاظ عبر الأجيال، في الصدور وفي السطور، من خلال أسانيد موثوق بها ومتَّصلة بالنبيّ –صلى اللَّه عليه وسلّم-. وفي ذلك، يقول المستشرق موير: “إنَّ المصحف الذي جمعه عثمان –رضي اللَّه عنه- قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حُفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يُذكر، بل نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها، والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة، وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم يُعدّ أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا”.
وفي المقابل، فإنك لا تجد أي دين آخر من الديانات التي ينتمي أهلها إلى نبي من الأنبياء، له سند متصل بذلك النبي. وعلى سبيل المثال، فإن الإنجيل الذي قد جاء به المسيح عيسى ابن مريم- عليه السلام- لم يُكتب في عهده، وإنما كانت كتابته بعد ما يُقارب 300 عامًا من رسالته، ومن ثم تعدّدت الأناجيل مع ما بها من اختلافات وتناقضات، وتعرّضت للمراجعات والتنقيحات، حتى أصبح لدينا اليوم أكثر من ستة آلاف إنجيل مختلف. ولم يتوقَّف الأمر عند هذا الحد، فمع مرور الوقت تعجز نصوص الإنجيل المحرَّفة أصلًا عن مواكبة التطورات والأحداث، فيعمد إليها النصارى من حين إلى آخر بمزيد من التنقيح والتحريف.
أما التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله اللَّه –سبحانه وتعالى– على موسى –عليه السلام-، وقد نزل باللغة الهيروغليفية، وهي لغته ولغة بني إِسرائيل في مصر في ذلك الزمان، أي قبل نشأة اللغة العبرية بأكثر من مائة سنة، إِذ العبرية – في الأصل– لهجة كنعانية. والسؤال: أين هي التوراة التي نزلت على موسى بالهيروغليفية؟ فهل لها أي وجود أو أثر في التراث الديني اليهودي؟ الجواب الذي يُجمع عليه اليهود: أنه لا وجود لهذه التوراة. والأمر الأهم من ذلك، هو أن التوراة نزلت على موسى –عليه السلام- بالهيروغيلفية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، بينما حدث أوّل تدوين لأسفار العهد القديم، وفي مقدمتها أسفار موسى الخمسة، على يدي “عزرا”، أي في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد، وبعد عودة اليهود من السبي البابلي (597 – 538 ق. م)، الأمر الذي يعني أن التراث اليهودي قد ظل تراثًا شفهيًا ومتقطّع السند لمدة ثمانية قرون، عبد خلالها بنو إِسرائيل الأوثان، وانقلبوا فيها على أنبيائهم في الكثير من الأحيان فقتلوهم.
وقد أخبرنا الله عز وجلّ في آيات القرآن عن تحريف اليهود للتوراة، وتحريف النصارى للإنجيل، وطالبهم بأن يتّبعوا رسوله مُحمَّد –صلى اللَّه عليه وسلّم- والكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن الكريم: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ (15) يَهْدِيْ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (16) المائدة.
إن القرآن الكريم، دستور الإسلام، هو الكتاب الوحيد الذي تكفّل اللَّه عزّ وجلّ بحفظه من أي تحريف أو تغيير أو تبديل. ومن واقع إيماننا الراسخ بقول ربنا عزّ وجلّ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) الحجر، فإننا على يقين تام واعتقاد جازم بأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم لا يختلف في شيء من مضمونه ولا نظمه وترتيبه عمّا هو عليه في اللَّوح المحفوظ، وأن كل آية وكل كلمة في القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن نزل بها الوحي من عند الله عزّ وجلّ.
والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يتكفّل اللَّه عز وجل بحفظ الكتب الأخرى؟ إذا تأمّلت جميع الكتب التي نزلت قبل القرآن الكريم، وفي مقدمتها التوراة والإنجيل، كانت خاصة بأمّة من الأمم، أو زمان من الأزمنة، ولم يُرد اللَّه عزّ وجل لها الخلود والدوام، بل أراد من هذه الكتب أن تكون مصدر إرشاد وتعليم لفترة من الزمن ولفئة من البشر، وما فيها من أحكام كانت ملبية لاحتياجات تلك الفترة الزمانية، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحد قبلي.. وذكر منها “وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة”. (رواه البخاري). ويفهم من ذلك أن بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- للناس كافة، وأن كل الأديان السماوية السابقة منسوخة بالإسلام، ومن عرفه ولم يؤمن به فهو هالك، ولا ينفعه إيمانه بالأنبياء السابقين. فالأديان السابقة جميعها كانت محدودة الزمان والمكان والمحتوى، ولذا روي عن المسيح عليه السلام قوله: “لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة”. (إنجيل متى 15-21). وفي المقابل، يقول اللَّه عزّ وجلّ في القرآن مخاطبًا عبده ونبيه مُحمَّدًا -صلى الله عليه وسلم-: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (28) سبأ. ولذلك حفظ اللَّه عز وجل القرآن الكريم، دون غيره من الكتب، لأنه دستور الدين الحق الذي ارتضاه للناس جميعًا، وهو الدين الأشمل والأكمل والأتم، فلا دين بعد الإسلام، ولا كتاب بعد القرآن.
المصدر:طريق القرآن