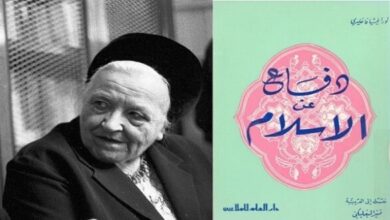صلة الأرض بالسماء

محمد عمر دولة
لم تعرف الدنيا قوماً يتآلفون مع الكون، ويتعارفون مع الناس بالمودّة والعون، كما عرفت ذلك من المسلمين. ولم تشهد البشرية رجالاً مؤمنين يوفون بالعهد، ويرعون وحي السماء في السرّاء والضرّاء كما هو شأن المسلمين.
فتاريخ أهل الكتاب مُسوّد بالخيانات، مشوّهٌ مثل تحريفهم للتوراة، أمّا اليهود فقد غضب الله عليهم، حينما صاروا (كمثل الحمار يحملُ أسفاراً)، وأمّا النصارى فقد ضيّعوا ما استُحفِظوا عليه من تعاليم المسيح – عليه السلام -، فضلّوا طريق التوحيد إلى متاهات الشرك بالله – تعالى -. وهكذا (كلما جاء أمةً رسولُها كذّبوه)، وقد أخبرنا النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه: (يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد)! وأعلَمَنا – صلى الله عليه وسلم – أن نوحاً – عليه السلام – الذي (ما آمن معه إلا قليل) يأتي يوم القيامة فيُقالُ له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. وفي حديث الإسراء نصيحة موسى – عليه السلام – لهذه الأمة في شأن الصلاة، وسلام إبراهيم الخليل – صلى الله عليه وسلم – على المسلمين مصداقاً لقول الله – تعالى -: (ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل).
فما الذي أوجب هذه الاستجابة لتلكم التوجيهات الربانية؟ إنه وعي هذه الأمة بفلسفة الوجود – كما وفّقها الله لما اختُلِف فيه من الحق – وإدراكها لحقيقة هذه الحياة، ومعانقتها للدور الرسالي المنوط بها في القيادة والشهادة والدعوة الراشدة إلى العبادة.
والذي تتفتح بصيرته على صفحات الوفاء لأهل الإسلام للذِّكر القادم من السماء، تتفتّق قريحته على أن استمداد الوعي إنما كان من الوحي، واستلهام الصواب ليس إلاّ من تعاليم الكتاب (بل هو آياتٌ بيّناتٌ في صدور الذين أوتوا العلم).
ولك أن تتأمّل جواب أنسٍ – رضي الله عنه – في البخاري لحفيده هشام بن زيد حين سأله عن حنين، قال هشام: “يا أبا حمزة! وأنت شاهدٌ ذلك؟ قال: وأين أغيبُ عنه؟!“، وقول أبي طلحة – رضي الله عنه – في أُحُد وهو يذبُّ عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: “بأبي أنت وأمي، لا تُشرِف يصيبك سهمٌ من سهام القوم. نحري دون نحرك“، وقول الصدِّيق – رضي الله عنه – في الموطّأ لمّا قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (لا أدري ما تُحدِثوا بعدي) فبكى أبو بكرٍ ثم بكى، ثم قال: “أئنا لكائنون بعدك؟!“، وما موقف عمر – رضي الله – عند وفاة النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى خانته رجلاه فلم تحملاه إلاّ لشدة ارتباطه بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وقوّة تعلّقه به. كيف وهو الذي قال للنبي – صلى الله عليه وسلم – حينما أعرض عنه – كما عزاه ابنُ حجر إلى أبي يعلى – “ما خيرُ حياتي وأنت معرِضٌ عني؟!“، كذلك قول فاطمة – عليها السلام -: “يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – التراب؟!”، وقولها: “ثم سارّني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعُه فضحكتُ“.
وليت شعري هل عاقب النبيُ – صلى الله عليه وسلم – المتخلّفين عن تبوك بأكثر من مقاطعته لهم. حتى (ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت وضاقت عليهم أنفسهم)، ورحم الله أمَّنا عائشة – رضي الله عنها – فقد أهمَّها في محنة الإفك أنها افتقدت حنان النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت – كما روى البخاري -: “يريبُني في وجعي أني لا أعرِف من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل عليَّ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – فيسلّم ثم يقول: (كيف تيكم؟)“.
وقد كان هؤلاء الرجال من مدرسة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – يحتسبون النظرة إلى وجه الكريم، والبسمة على شفتيه الشريفتين كما قال عقبة بن عامر – رضي الله عنه -: “فكانت آخر نظرةٍ نظرتُها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم –“، وقال كعب بن مالك وهو يحدّث عن تخلُّفه في تبوك: “فلمّا سلمتُ عليه تبسَّم تبسُّم المغضَب“. ولذلك كانوا – لله درّهم – يفرحون بتضحيتهم بأرواحهم لأجل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كما هو شأن حرام بن مِلحان – خال أنس – لمّا طُعِن يوم بئر معونة فإنه: “قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه، وقال: فزت وربّ الكعبة“، ويحزنون إذا حُرِموا كما حدّثنا القرآن عن (الذين إذا ما أتوْك لتحملهم قلتَ لا أجدُ ما أحملكم عليه تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألاّ يجدوا ما يُنفِقون).
وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم وهو معلّمهم – يعرف أنهم لا مغنم لهم إلاّ صحبته، ولا مطلب لهم إلاّ رؤية طلعته؛ ولذلك قال لهم يوم حنين: (أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم – وفي روايةٍ بالشاة والبعير – إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى بيوتكم؟). وقال – صلى الله عليه وسلم -: (أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكِلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب) قال عمرو: “فما أُحِبُّ أنّ لي بكلمة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حُمر النّعم“.
هذا الارتباط الوثيق بين المسلمين والدّين، سببه أنهم: (يُمسِّكون بالكتاب) ذلك الحبل المتين، ويتّبعون الرسول الأمين – صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك عبّر النبي – صلى الله عليه وسلم – عن هذا الرباط بـ (حلاوة الإيمان) خير تعبير حيث قال: (يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذَف في النار)، وسأل هرقلُ – في حديث الوحي – أبا سفيان قبل إسلامه: “هل يرتد أحدٌ منهم سخطةً لدينه؟ قال: لا“، “قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب“.
فهذا الاستشعار لقيم السماء هو الذي أثمر في قلوبهم ذاك الوفاء. فصاروا يراقبون ثنايا النفس، ويتلمّسون حنايا الوجدان (إذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون)، حتى قيل لامرأةٍ مجذومةٍ نهاها عمر أن تطوف بالبيت – كما في الموطّأ -: “إن الذي كان قد نهاكِ قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنتُ لأطيعه حياً واعصيه ميّتاً“، فقد خالطت الطاعة قلبها، وسارت بين لحمها وعظمها. ورحم الله أمّ أيمن، حين زارها الشيخان – رضي الله عنهما -، فلمّا رأتهما بكت. فأخبراها بأن ما عند الله خيرٌ لرسول الله. فقالت: “إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيّجتهما على البكاء. فطفقا يبكيان معها!
المصدر: شبكة المشكاة