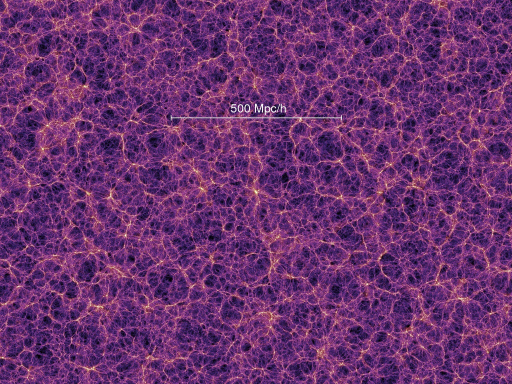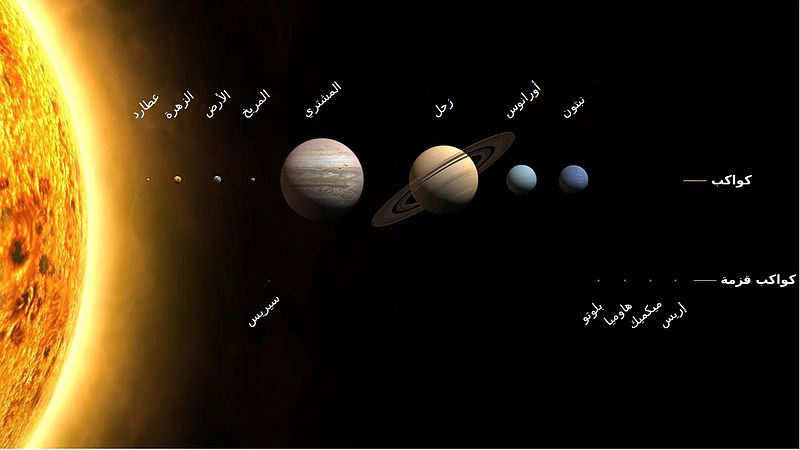الإعجاز التركيبي (الجملة القرآنية)


سبقت الإشارة إلى عمل عبد القاهر الجرجاني في “دلائل الإعجاز” حيث جعل النظم هو المعيار الحقيقي للبلاغة، وجعل مدار الإعجاز البياني عليه، ونسوق هنا بعض مظاهر الإعجاز في تركيب الجملة القرآنية:
أولاً: الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي:
الجملة القرآنية مؤلفة من كلمات وحروف ذات أصوات يستريح لتآلُفِها السمع والصوت، والنطق، ويتكون من اجتماعها على الشكل الذي رتبت عليه، نسق جميل ينطوي على إيقاع خفي رائع، ما كان لِيَتِمَّ إلا بالصورة التى جاءت عليها الآيات، وأى وجه من التغيير أو التبديل أو النقص أو الزيادة يضيع معه هذا الجمال والإبداع القرآني .
تأمل قوله تعالى: {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ} (القمر: 11 ـ 14)، وتأمل تناسق الكلمات في كل جملة منها، ثم دقق نظرك وتأمل تآلف الحروف الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرها، ثم أمعن في تآلف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضها، فإنك إذا تأملت في ذلك علمت أن هذه الجمل القرآنية إنما صُبَّتْ من الكلمات والحروف والحركات في مقدار، وأن ذلك إنما قُدِّر تقديرًا بعلم اللطيف الخبير، وهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على ضبط الكلام بهذه القوالب الدقيقة.
وعلى الرغم من أن القرآن لا ينضبط بشيء من أعاريض النظم وأوزانه المعروفة، إلا أنك تشعر مع ذلك بتوقيع موزون من تتابع كلماته، بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنًا مطربًا يفرض نفسه على صوت القارئ العربي كيفما قرأ ـ إذا كانت قراءته صحيحة ـ كما تلاحظ لدى قراءتك لهذه الآيات.
ولعل من أبرز آثار هذه الظاهرة أن حفظ القرآن غيبًا أيسرُ على الإنسان من حفظ سائر أنواع النثر؛ ذلك لأنه منضبط بأوزان وإيقاعات خاصة به، فيسهل بذلك حفظه والتنبه للخطأ الذي قد يقع القارئ فيه عندما يقرؤه غيبًا. بل المعروف لدى من مارس حفظ القرآن أن الخطأ قلَّما يقع في حفظه وضبطه إلا من وجه واحد، هو ما قد يكون بين الآيات من تشابه، فيأتي الخطأ من خلط آية بأخرى والوقوع في اللبس بينهما.
ثانيًا: دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معنى:
وهذه ظاهرة جلية تستطيع أن تتبينها في طريقة التعبير القرآني، مهما اختلفت بحوثه وموضوعاته، لا تجد في الجملة القرآنية كلمة زائدة يصلح المعنى مع الاستغناء عنها، ولا تستطيع أن تترجم معناها بألفاظ عربية من عندك إلا في عدد من الجمل مهما حاولت الإيجاز والاختصار.
ولنستعرض طائفة من الأمثلة على ذلك، والقرآن كله ـ كما قلنا ـ مثال على هذه الحقيقة:
حدثنا القرآن عن الضمانات التي أعطاها لآدم بعد خلقه، مِمَّا يحتاجه الإنسان في حياته من كل ما يدخل في مقومات بقائه ورفاهية عيشه. لقد وضع البيان الإلهي هذه الاحتياجات كلها في جملتين فقط وهما قوله عز وجل خطابًا لآدم عليه السلام: {إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى * وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى} (طه: 118 -119)؛ فتأمل في هاتين الجملتين وألفاظهما، وكيفية صياغتهما، وكيف أنهما جَمَعَتَا أصول معايش الإنسان كلها من طعام وشراب وملبس ومأوى. وانظر كيف عبر عن تأمين حاجته إلى المسكن والمأوى بقوله: {وَلاَ تَضْحَى}، أي لك أن لا تصيبك شمس الضحى أو يؤذيك لفحها بما نهيئه لك من المسكن الذي يؤويك.
وانظر إلى هذه الآية، وقد تضمنت حكمًا من الأحكام الشرعية المهمة، وهي قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ} (الأنفال: 58). تأمل صياغة هذه الآية وطريقة دلالتها على المعنى الذي تعبر عنه، تجد نفسك أمام أسلوب فريد ليس من دأب الإنسان أن يتأتى له التعبير بمثله.
يقول الزمخشرى وهو يحاول التعبير عن معنى هذه الآية بألفاظ عربية من عنده:
“ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل معنى هذه الآية، لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أُودِعَتْه حتى تبسط مجموعها، وتصل مقطوعها، وتُظْهٍِر مستورها، فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانةً أو نقضًا، فأَعْلِمْهم أنك قد نقضت ما شرطت عليهم، وآذِنهم بالحرب، لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء”1.
وحسبك أن تعلم أن الآيات المتضمنة لأحكام التشريع، قد لا تزيد على ثلاثمائة آية إلا شيئًا يسيرًا، وهي لا تبلغ معشار النصوص الفقهية التي دوَّنها الفقهاء فيما بعد، ولكن قد ثبت بما لا يَدَعُ مَجالا للشك أن من أبرز مظاهر الإعجاز في هذه الآيات أن الطريقة الفريدة في صياغة وتراكب جملها، تجعلها متسعة للدلالة على ذخر من المعاني الكثيرة التي لا يمكن التعبير عنها بطريقتنا المألوفة، إلا بواسطة مجلدات.
خذ على سبيل المثال هذه الآية:
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة: 233).
فهذه آية واحدة صيغت من ستة أسطر قرآنية، أي ما لا يزيد على ستين كلمة، وقد تضمنت ثلاثة وعشرين حكمًا مما يتعلق بنظام الأسرة، لم يُسْتَخْرَجْ واحدٌ منها تَمَحُّلاً ولا تكلُّفًا، بل هو بَيْنَ أن تكون الآية دلت عليه بصريح المنطوق أو بجلي المفهوم أو بمقتضى النص. وأنت لو رحت تحاول التعبير عن هذه الأحكام بصياغة جلية دون اختصار مُخِلٍّ أو إطالة من غير لزوم، لاقتضى ذلك منك ما لا يقل عن خمسة وعشرين سطرًا من الكلام، أي خمسة أضعاف النص القرآني.
وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب الله عز وجل، وتأمل كيف صيغت فيما لا يزيد على ثلاثة عشر سطرًا من أسطر القرآن، موزعة في آيتين. فلقد حوت هاتان الآيتان ـ في غير إخلال ولا تكلف ـ أحوال الوارثين ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوال. ولقد انبثق من هاتين الآيتين فنٌّ مستقل برأسه يمثل شطرًا كبيرًا من الأحكام الشرعية الإسلامية، وهو ما يسمى بعلم الميراث، وقد كتبت فيه مؤلفات مستقلة. وإنك لتعجب كيف اتسع مضمون آيتين من القرآن لمدلولات كتاب برأسه، ولكن انظر وتأمل وقارن، فستجد أن هذا الذي تعجب منه حقيقة ثابتة2.
قال تعالى: {الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} (هود: 1)، ذلك خير ما توصف به الجملة القرآنية، فهي بناء قد أحكمت لبناته، ونُسِّقَتْ أدقَّ تنسيق، لا تُحِسُّ فيها بكلمة تضيق بمكانها، أو تنبو عن موضعها، أو لا تعيش مع أخواتها، حتى صار من العسير، بل من المستحيل، أن تغيِّر في الجملة كلمة بكلمة، أو أن تستغني فيها عن لفظ، أو أن تزيد فيها شيئًا، وصار قُصارَى أمرك إذا أردت معارضة جملة في القرآن، أن ترجع بعد طول المطاف إليها، كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظ، وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها ـ وهي بحر خضم ـ ما تؤدي به تلك المعاني مما اختاره القرآن لهذا الأداء.
والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي، فتصوره بألفاظها، لتلقيه في النفس، حتى إذا استكملت الجملة أركانها، برز المعنى ظاهرًا، فيه المهم والأهم، فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب، ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا مَعْدَى عنها، وإلاَّ اختلَّ البناء وانهار.
خذ مثلاً قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة: 5)؛ فإنك ترى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد ورجاء المستعين، فلا جَرَمَ وهو مناط الاهتمام أن يتقدم كما يتقدم كل ما ُيْهَتُّم به ويُعْنَى.
وخذ قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (البقرة: 127). تجد إسماعيل معطوفًا على إبراهيم، فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت، ولكن تأخره في الذكر يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور ثانوي، أما الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم (قيل: كان إبراهيم يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة) فنزلت الآية وكأنما ستنسى دور إسماعيل لثانويته، ثم ذكرته بعد أن انتهت من تكوُّنها.
وخذ قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ} (البقرة: 45)، تجد المستعان عليه في الآية غير مذكور، لا تخففًا من ذكره، ولكن ليوحى هذا الحذف إلى النفس أن كل ما يقوم أمام المرء من مشقة وما يعترضه من صعوبات، يُستعان على التغلُّب عليه، بالصبر والصلاة.
تمضي الجملة القرآنية، وقد كُوِّنت من كلمات قد اختيرت، ثم نسقت في سلك من النظام، فلا ضعف في تأليف، ولا تعقيد في نظم، ولكن حسن تنسيق، ودقة ترتيب، وإحكام في تلاؤم. واقرأ قوله تعالى:
{ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (البقرة:2ـ 5) تَرى آيات قد التحم نسجها، وارتبط بناء بعضها ببعض، تسلم الجملة إلى أختها في التئام واتساق، فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال، ووصفته الجملة الثانية بأنه لا يعلق به الريب، لا في أخباره ولا في نسبته إلى الله، وفي الجملة الثالثة جعله هاديًا لأولئك الذين يخشون الله ويتقونه، ومضت الآية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن، فهم الذين يوقنون بما أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونها، ويقومون بواجبهم لله فيؤدون الصلاة كما يجب أن تؤدى، وواجبهم للمجتمع فيقدِّمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والفقير، ولا يتعصبون لرسول دون رسول، بل يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ورأس الإيمان وأساسه هو إيمانهم باليوم الآخر؛ لأن ذلك الإيمان يدفع إلى العمل الصالح، وينهى عن المنكر والبغي، فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ربهم وكانوا هم المفلحين.
ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوي بين جمل الآية القرآنية، وكثير من الجمل في القرآن توحي إليك ألفاظها بمعانٍ لا يستطيع لفظ أن يستوعبها، بل يترك للنفس أمر إدراكها، وحسبنا أن نشير من ذلك إلى قوله عز وجل: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ… } (البقرة: 84 ـ 85) .
أولاً: توحي جملة {ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء} بالفرق بين ما كان يجب أن يكونوا عليه، وما هم عليه حقيقة، فأي خيبة أمل تملأ النفس منهم!؟
ثانيًا: تدل هذه الجملة القصيرة على سخط شديد، وتعجب لأمور ما كان ينتظر حدوثها، ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها3.
ومن ذلك استعمال أحد الفعلين الماضي والمضارع موضع صاحبه، فيأتي بالمضارع مكان الماضي لإحضار صورة الفعل أمام السامع حتى كأنه يشاهده؛ وليس ذلك ما يثيره الفعل الماضي؛ لأن سامعه قد يكتفي بأن يتخيل فعلاً قد مضى، وربما لا يستحضر صورته أو تكرره. واقرأ قوله تعالى: {أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} (البقرة: 87) تجد الفعل المضارع قد صوَّر جريمتهم كأنهم يرتكبونها في اللحظة الحاضرة، وفي ذلك من التشنيع عليهم ما فيه.
وقوله تعالى: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ} (فاطر:9)، ففي (تثير) ما يحضر تلك الصورة الطبيعية الدالة على القدرة الباهرة.
وقوله تعالى: {حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (الحج: 31)؛ ففي ذكر المضارع استحضار صورة خطف الطير له، وهُوِيِّ الريح به.
ويستخدم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأكيد وقوع الفعل، حتى كأنه قد وقع، وذلك يكون فيما يُسْتَعْظَم من الأمور، ومن أمثلته قوله سبحانه: {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} (النمل: 87)، وقوله تعالى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً} (الكهف: 47)، وقوله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (النحل:1)، وقوله تعالى: {وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ} (إبراهيم: 21)، وفي الإتيان بالماضي هنا من إيقاع الرهبة في النفوس ما فيه؛ لأن الفعل كأنه قد تَمَّ والقرآن يتحدث عنه، وفي استخدام الماضي في قوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (البقرة: 160) إشارة إلى ما اتَّسم به هؤلاء التائبون من مبادرة وإسراع إلى التوبة، وفي قوله تعالى:{وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} (البقرة:165 ـ 167) تأكيد لما سيحدث في المستقبل حتى كأنه حدث4.
***************************
(1) الكشاف 2/165.
(2) من روائع القرآن، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ص 144ـ 147.
(3) من بلاغة القرآن، د. أحمد أحمد بدوي، ص 105 ـ 107.
(4) السابق، ص 111 ـ 112.